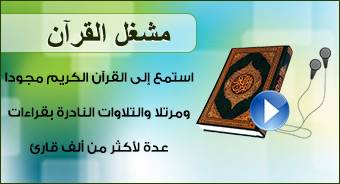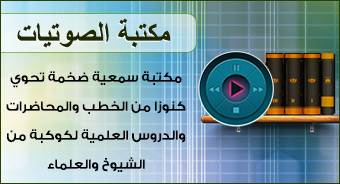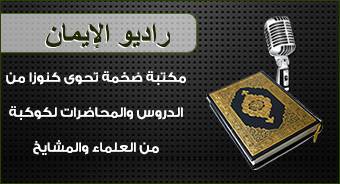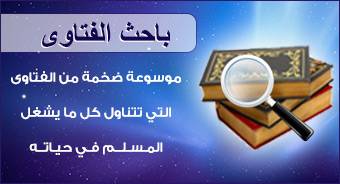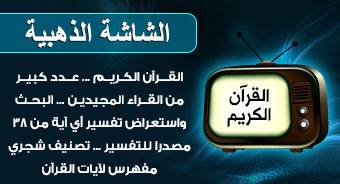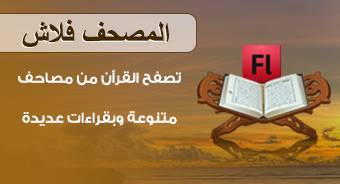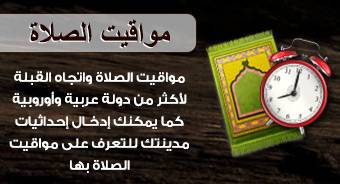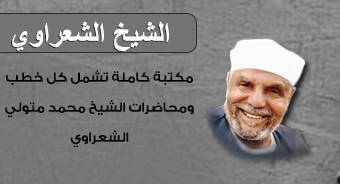|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم مقاييس اللغة ***
(ثني) الثاء والنون والياء أصلٌ واحد، وهو تكرير الشّيء مرّتين، أو جعلُه شيئين متوالييَن أو متباينين، وذلك قولك ثَنَيْت الشّيءَ ثَنْياً. والاثنان في العدد معروفان. والثِّنَى والثنْيانُ الذي يكون بعد السّيِّد، كأنّه ثانِيهِ. قال: تَرَى ثِنَانا إذا ما جاءَ بَدْأَهُمُ *** وبَدْؤُهُم إنْ أتانا كان ثُنْيانا يروى: "ثُنْيانُنا إن أتاهُمْ كانَ بَدْأَهُم". والثِّنَى: الأمْرُ يعادُ مرّتين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاثِنَى في الصَّدَقَة" يعني لا تُؤخذ في السّنَة مرَّتين". وقال معن: أفي جَنْبِ بَكْرٍ قطَّعَتْنِي مَلامةً *** لَعَمْري لقد كانت مَلامَتُها ثِنَى وقال النّمر بن تَولَب: فإذا ما لم تُصِب رشداً *** كان بعضُ اللَّومُ ثُنْيانا ويقال امرأةٌ ثِنْيٌ ولدت اثنين، ولا يقال ثِلْثٌ ولا فَوقَ ذلك. والثِّنَاية: حبلٌ من شَعَرٍ أو صوف. ويحتملُ أنّه سمّي بذلك لأنّه يُثْنَى أو يُمكن أن يُثْنَى. قال: * [و] الحَجَرُ الأَخْشَنُ والثِّنَايهْ * والثُّنْيَا من الجَزُور: الرأسُ أو غيرُه إذا استثناه صاحبُه. ومعنى الاستثناء من قياس الباب، وذلك* أنّ ذكره يثنَّى مرّةً في الجملة ومرّةً في التفصيل؛ لأنّك إذا قلت: خَرَجَ الناسُ، ففي الناس زيدٌ وعمروٌ، فإذا قلتَ: إلا زيداً، فقد ذكرتَ به زيداً مرةً أخرى ذكراً ظاهراً. ولذلك قال بعضُ النحويِّين: إنّه خرج مما دخل فيه، فعمل فيه ما عمل عشرون في الدِّرْهم. وهذا كلامٌ صحيحٌ مستقيم. والمِثْناةُ: طَرَف الزِّمام في الخِشاش، كأنّه ثاني الزّمام. والمَثْناة: ما قُرِئ من الكتاب وكرِّر. قال الله تعالى: {ولَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي} [الحجر 87] أراد أنّ قراءَتها تثَنَّى وتُكَرَّرُ. (ثنت) الثاء والنون والتاء كلمةٌ واحدة. ثَنِتَ اللّحمُ تغيّرَتْ رائحتهُ. وقد يقولون ثَتِن. قال: * وثتِنَتْ لِثاتُه دِرْحايَهْ *
(ثهل) الثاء والهاء واللام كلمةٌ واحدة وهو جبَل يقال لـه ثهْلان، وهو مشهور. وقد قالوا -وما أحسبه صحيحاً- إنّ الثَّهَلَ الانبساطُ على وجه الأرض.
(ثوي) الثاء والواو والياء كلمةٌ واحدة صحيحة تدلُّ على الإقامة. يقال ثَوَى يثْوِي فهو ثاوٍ. وقال: آذَنَتْنَا بِبَيْنها أسماءُ *** ربَّ ثاوٍ يُمَلّ منه الثَّواءُ ويقال أثْوَى أيضاً. قال: أَثْوَى وَقَصَّرَ لَيْلُه ليُزَوَّدا *** فَمضَى وأخلف من قُتَيْلَة مَوْعِدا
والثَّوِيَّة والثَّايَة: مأوى الغَنَم. والثَّويَّة: مكان. وأمُّ مَثْوَى الرّجلِ: صاحبةُ منزلهِ. والقياس كلُّه واحد. والثّايَة أيضاً: حِجارةٌ تُرفَع للرّاعي يَرجع إليها لَيْلاً، تكونُ علماً له. (ثوب) الثاء والواو والباء قياسٌ صحيحٌ من أصلٍ واحد، وهو العَوْدُ والرُّجوع. يقال ثاب يثُوب إذا رَجَع. والمَثَابةُ: المكان يَثُوب إليه النّاس. قال الله تعالى: {وَإذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً} [البقرة 125]. قال أهل التفسير: مثابة: يثُوبون إليه لا يَقْضُون منه وَطَراً أبداً. والمَثَابة: مَقام المُستَقِي على فَمِ البِئرْ. وهو مِنْ هذا، لأنّه يثُوب إليه، والجمع مَثَابات. قال: وما لـمَثَاباتِ العُروشِ بَقيَّةٌ *** إذا استُلَّ من تحت العُرُوشِ الدَّعائمُ وقال قَوم: المَثَابة العدد الكبير. فإنْ كان صحيحاً فهو من الباب، لأنهم الفئة التي يُثَابُ إليها. ويقال ثَابَ الحوضُ، إذا امتلأ. قال: * إن لم يثُبْ حَوْضُك قَبْلَ الرِّيّ * وهكذا كأنّه خلا ثم ثاب إليه الماء، أو عاد ممتلئاً بعد أنْ خلا. والثّوابُ من الأجْر والجزاء أمرٌ يُثابُ إليه. ويقال إنّ المَثابة حِبالةُ الصَّائد، فإن كان هذا صحيحاً فلأنّه مَثَابة الصَّيد، على معنى الاستعارة والتّشبيه. قال الراجز: مَتَى مَتَى تُطَّلَعُ المَثَابَا *** لعلَّ شَيْخاً مُهْتَراً مُصابَا يعني بالشّيخِ الوَعِلَ يَصِيدُه. ويقال إنّ الثَّوابَ العَسَلُ؛ وهو من الباب، لأنّ النّحلَ يثُوبُ إليه. قال: فهو أحْلَى مِنَ الثَّوابِ إذا *** ذُقْتَُ فَاهَا وبَارِئِ النَّسَمِ قالوا: والواحدُ ثَوَابة. وثَوَابٌ: اسمُ رجلٍ كان يُضْرَب به المثل في الطَّوَاعِيَة، فيقال: "أطْوَعُ مِنْ ثواب". قال: وكنتُ الدّهر لَستُ أُطِيعُ أنْثَى *** فصرْتُ اليومَ أطْوَعَ مِن ثَوابِ والثوب الملبوس محتملٌ أن يكون من هذا القياس؛ لأنّه يُلْبَس ثم يُلبَس ويثاب إليه. وربَّما عبَّروا عن النفس بالثَّوب، فيقال هو طاهر الثِّياب. (ثور) الثاء والواو والراء أصْلانِ قد يمكن الجمعُ بينهما بأدنَى نظَرٍ. فالأوّل انبعاثُ الشيء، والثاني جنسٌ من الحيوان. فالأوّل قولُهم: ثار الشيءُ يَثُور ثَوْراً وثُؤُوراً وثَوَراناً. وثارت الحصْبة تثور. وثاوَرَ فلانٌ فلاناً، إذا وَاثَبَه، كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ثار إلى صاحبه. وَثَوَّر فلانٌ على فلانٍ شرّاً، إذا أظهره. ومحتملٌ أن يكون الثَّور فيمن يقول إنّه الطُّحلب من هذا، لأنّه شيءٌ قد ثارَ على مَتْن الماء. والثاني الثَّور من الثِّيران، وجمع على* الأثْوار أيضاً. فأمَّا قولُهم للسيّد ثَوْرٌ فهو على معنَى التَّشبيه إن كانت العرب تستعمله. على أنّي لم أرَ به روايةً صحيحة. فأمّا قول القائل: إنّي وقتلي سُليكاً ثمّ أعقلَهُ *** كالثَّور يضرَب لَمّا عافَتِ البَقَرُ فقال قومٌ: هو الثّوار بعينه، لأنّهم يقولون إنّ الجنّيَّ يركب ظَهر الثَّور فيمتنع البقرُ من الشُّرب. وهو من قوله: وَما ذَنْبُه أنْ عافَتِ الماءَ باقرٌ *** وما إنْ تَعافُ الماءَ إلاّ ليُضْربا وقال قوم: هو الطُّحْلب. وقد ذكرناه. وثَوْر: جَبَل. وثور: قومٌ من العرب. وهذا على التَّشبيه. فأمَّا الثَّور فالقطعة من الأَقِطِ. وجائز أن يكون من. (ثول) الثاء والواو واللام كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على الاضطراب، وإليها يرجع الفُروع. فالثَّوَلُ داءٌ يصيب الشّاةَ فتسترخي أعضاؤها، وقد يكون في الذُّكْرَانِ أيضاً، يقال تيسٌ أثْوَلُ، وربّما قالوا للأحمق البطيء الخَيْر أثْوَل؛ وهو من الاضطراب. والثَّول الجماعة من النَّحل من هذا، لأنّه إذا تجمَّع اضطراب فتردّدَ بعضُه على بعضٍ. ويقال تَثَوَّلَ القومُ على فُلان تَثوُّلاً، إذا تجمّعُوا عليه. (ثوم) الثاء والواو والميم كلمةٌ واحدة، وهي الثُّومَة من النَّبات. وربَّما سمَّوا قبِيعة السّيف ثُومةً. وليس ذلك بأصل. (ثوخ) الثاء والواو والخاء ليس أصلاً؛ لأن قولهم ثاخَت الإصبعُ إنّما هي مبدلة من سَاخت؛ وربّما قالوا بالتاء: تاخت. والأصل في ذلك كلِّه الواو. قال أبو ذُؤيب: * فَهْيَ تَثُوخ فيها الإصْبَعُ *
(ثيل) الثاء والياء واللام كلمةٌ واحدة، وهي الثِّيلُ، وهو وِعاء قضيب البعير. والثِّيل: نبات يشبك بعضُه بعضاً. واشتقاقه واشتقاق الكلمة التي قبله واحد. وما أُبْعِدُ أنْ تكون هذه الياءُ منقلبةً عن واو، تكون من قولهم ثثوَّلوا عليه، إذا تجمّعوا.
(ثأر) الثاء والهمزة والراء أصلٌ واحد، وهو الذَّحْل المطلوب. يقال ثأرتُ فلاناً بفلانٍ، إذا قتَلْتَ قاتلَه.قال قيس بنُ الخَطِيم: ثأرتُ عَدِيّاً والخَطِيمَ فلم أُضِعْ *** وصيَّةَ أشياخٍ جُعِلْتُ إزاءَهَا ويقال "هو الثَّأْر المُنِيم"، أي الذي إذا أدرك صاحبه نام. ويقال في الافتعال منه اثّأَرتُ. قال لَبيد: والنِّيبُ إنْ تَعْرُ مِنّي رِمّةً خَلَقاً *** بعد الممات فإنّي كنتُ أتَّئِرُ فأمّا قولهم استَثْأَرَ فلانٌ فلاناً إذا استغاثَهُ، فهو من هذا؛ لأنّه كأنّه دعاه إلى طلب الثَّأر. قال: إذا جاءَهم مُسْتَثْئِرٌ كانَ نصرُهُ *** دعاءً ألاَ طِيُروا بكلِّ وَأىً نَهْدِ والثُّؤْرةُ: الثَّأْرُ أيضاً. قال: * بني عامرٍ هل كنتُ في ثُؤْرَتي نِكْسَا * (ثأط) الثاء والهمزة والطاء كلمةٌ واحدة ليست أصلاً. فالثأْطَةُ الحَمْأة والجمع ثَأْط. وينشدون: * في عَينٍ ذي خُلُبٍ وثَأْطٍ حَرْمَدِ * وإنما قلنا ليست أصلاً لأنّهم يقولونها بالدال، فكأنّها من باب الإبدال. (ثأد) الثاء والهمزة والدال كلمةٌ واحدة يشتقّ منها، وهي النَّدَى وما أشبَهَه. فالثَّأْدُ النَّدى. والثَّئِد النّدِيُّ اللّيِّن. وقد ثَئِدَ المكانُ يَثْأَدُ. قال: هل سُوَيْدٌ غيرُ لَيْثٍ خادِرٍ *** ثَئِدَتْ أَرْضٌ عليه فانتَجَعْ فأمّا الثَّأْداء على فَعَلاء وفَعْلاء فهي الأَمَة، وهي قياس الباب، ومعناهما واحد. وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما كنت فيها بابنِ ثَأْداء". وربما قلبوه فقالوا: دَأْثَاء. وأنشدوا: وما كُنَّا بني ثَأْدَاءَ لمَّا *** شفَيْنَا بالأسِنَّةِ كُلَّ وِتْرِ (ثأي) الثاء والهمزة والياء كلمةٌ واحدة تدلُّ على فسادٍ وخَرْم. فالثَّأيُ على مثال الثَّعْي الخَرْم؛ يقال: أثأتِ الخارِزة الخَرْزَ* تُثْئيهِ إذا خرمَتْه. ويقال أثْأَيْتُ في القوم إثْآءً جَرَحْتُ فيهم. قال: يا لك مِنْ عَيْثٍ ومن إثآءِ *** يُعْقِبُ بالقَتْلِ وبالسِّباءِ
(ثبت) الثاء والباء والتاء كلمةٌ واحدة، وهي دَوامُ الشيء. يقال: ثَبَتَ ثباتاً وثُبُوتاً. ورجل ثَبْتٌ وثبيت. قال طَرَفَةُ في الثَّبيت: فالهَبيت لا فؤادَ لـه *** والثّبيت ثبته فَهَمُه (ثبج) الثاء والباء والجيم كلمةٌ واحدةٌ تتفرّع منها كَلِمٌ، وهي مُعْظَمُ الشيءِ ووَسَطُهُ. قال ابنُ دريد: ثَبَج كلِّ شيءٍ وسطُه. ورجل أثْبَجُ وامرأةٌ ثَبْجاء، إذا كان عظيمَ الجوفِ. وثَبَجَ الرّجُل، إذا أقْعَى على أطراف قدمَيْهِ كأنّه يستنجي وَتَراً. قال الراجز: إذا الكُماةُ جَثَمُوا على الرُّكَبْ *** ثَبَجْتُ يا عَمْرُو ثُبُوجَ المُحْتَطِبْ وهذا إنما يُقال لأنّه يُبْرِزُ ثَبَجَه. وجمع الثَّبَجِ أثْباجٌ وثُبُوج، وقومٌ ثُبْج جمع أثْبَجَ. وتَثَبَّجَ الرجلُ بالعصا إذا جعَلَها على ظهره وجعل يديه من ورائها. وثَبَجُ الرّمْل مُعْظَمُه، وكذلك ثَبَجُ البَحْر. فأمّا قولهم ثبّج الكلامَ تثبيجاً فهو أن لا يأِتيَ به على وَجْهِهِ. وأصله من الباب، لأنه كأنه يجمعه جمعاً فيأتي به مجتمعاً غير ملخَّص ولا مفصّل. (ثبر) الثاء والباء والراء أصولٌ ثلاثة: الأول السهولة، والثاني الهلاك، والثالث المواظبةُ على الشيء. فالأرض السَّهلة هي الثَّبْرَة. فأمّا ثَبْرةُ فموضعٌ معروف. قال الراجز: نجيْتُ نَفْسِي وتركت حَزْرَه *** نِعم الفَتَى غادرتُه بِثَبْرَه * لن يُسْلِمَ الحُرُّ الكريمُ بِكْرَهْ *
قال ابنُ دُريد: والثَّبْرَةُ ترابٌ شبيه بالنُّورَة إذا بلغ عِرْقُ النَّخْلةِ إليه وقف، فيقولون: بلغت النخلةُ ثَبْرَةً من الأرض. وثَبِيرٌ: جبل معروف. ومَثْبِرُ النّاقة: الموضع الذي تطرح فيه ولدها. وثَبَرَ البحرُ جَزَرَ، وذلك يُبْدِي عن مكان ليِّنٍ سَهل. وأما الهلاكُ فالثُّبُور، ورجل مثبور هالك. وفي كتاب الله تعالى: {دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً} [الفرقان 13]. وأمّا الثالث فيقال: ثابَرْت على الشيء، أي واظَبت. وذكر ابنُ دريدٍ: تثابَرَتِ الرِّجالُ في الحرب إذا تواثَبَتْ. وهو من هذا الباب الأخير. (ثبن) الثاء والباء والنون أصلٌ واحد، وهو وعاء من الأوعية. قالوا: الثَّبْنُ اتِّخاذُك حُجْزَةً في إزارك، تجعل فيها ما اجتنيْتَه من رُطبٍ وغيره. وفي الحديث: "فليأكُلْ ولا يتَّخِذْ ثِبانا". وقال ابن دريد قياساً ما أحسبه إلاّ مصنوعاً، قال: المَثْبَنَة: كيسٌ تتخذ فيه المرأة المرآةَ وأداتَها. وزعم أنها لغة يمانية. (ثبي) الثاء والباء والياء أصلٌ واحد، وهو الدَّوام على الشيء. قاله الخليل. وقال أيضاً: التَّثْبِيَة الدَّوام على الشيء، والتثبِية الثَّناءُ على الإنسان في حياته. وأنشَدَ لِلبيد: يُثَبِّي ثناءً مِنْ كريم وقولُه *** ألا انعَمْ على حُسْن التحيّةِ واشربِ فهذا أصلٌ صحيح. وأمّا الثُّبَةُ فالعُصْبة من الفُرسان، يكُونُون ثُبَةً، والجمع ثُبَاتٌ وثُبُونَ. قال عمرو: فأمّا يَومَ خَشْيَتِنا عليهمْ *** فتُصْبِحُ خيلُنا عُصَباً ثُبِينا قال الخليل: والثُّبَة أيضاً ثُبَةُ الحوض، وهو وَسطه الذي يثوب [إليه الماء]. وهذا تعليلٌ من الخليل للمسألة، وهو يدلّ على أنّ الساقط من الثبَة واوٌ قبل الباء؛ لأنّه زعم أنّه من يثوب. وقال بعد ذلك: أمّا العامّة فإنهم يصغِّرونها على ثُبَيَّة، يَتْبعون اللَّفظ. والذين يقولون ثُوَيبة في تصغير ثُبَةِ الحوض، فإنهم لزموا القياسَ فردُّوا إليها النقصان في موضعه، كما قالوا في تصغير رَوِيَّة رُوَيِّئة لأنها من روّأت. والذي عندي أنَّ الأصلَ في ثبة الحوض وثُبةِ الخيل واحدٌ، لا فرق بينهما. والتصغير فيهما ثُبَيّة، وقياسهُ ما بدأْنا به الباب في ذكر التثبية، وهو من ثبَّى على الشيءِ إذا دام. وأمّا اشتقاقه الرّويّة وأنها من روّأت ففيه نظر.
(ثتن) الثاء والتاء والنون ليس أصلاً. يقولون: ثَتِن اللحم: أَنْتَنَ، وثَتِنَتْ لِثَتُه: استرخَتْ وأَنْتنَت. قال: * ولِثَةً قد ثتِنَتْ مُشَخَّمَهْ * وإنما قلنا ليس أصلاً لأنهم يقولون مرةً ثَتِنَتْ، ومرّةً ثَنِتَتْ.
(الثُّفْروق) : قِمَع التَّمْرة. وهذا منحوت من الثَّفْر وهو المؤخّر، ومن فَرَقَ؛ لأنه شيءٌ في مؤخَّر التمرة يفارقها. وهذا احتمالٌ ليس بالبعيد. (الثَّعْلَب) : مَخْرج الماء من الجَرِين. فهذا مأخوذٌ من ثَعَب، واللام فيه زائدة. فأمَّا ثَعْلبُ الرُّمح فهو منحوتٌ من الثَّعْب ومن العَلْب. وهو في خِلقته يشبه المَثْعَب، وهو معلوبٌ، وقد فسر العَلْب في بابه. ووجهٌ آخر أنْ يكون من العَلْب ومن الثَّلِب، وهو الرّمح الخوّار، وذلك الطَّرَف دقيقٌ فهو ثَلِبٌ.
ومن ذلك (الثُّرمطة) وهي اللَّثَق والطِّين. وهذا منحوتٌ من كلمتين من الثَّرْط والرَّمْط، وهما اللَّطخ. يقال ثُرِط فلانٌ إذا لُطِخ بعَيْب. وكذلك رُمِط. ومن ذلك (اثبجَرَّ) القومُ في أمرهم، إذا شكُّوا فيه وتردَّدُوا من فَزَعٍ وذُعْرٍ. وهذا منحوتٌ من الثَّبَج والثُّجْرة. وذلك أنهم يَتَرَادُّونَ ويتجمَّعون. وقد مضى تفسيرُ الكلمتين.
(جح) في المضاعف. الجيم والحاء يدلُّ على عِظَم الشيء، يقال للسيِّد من الرّجال الجَحْجاح، والجمع جَحاجحُ وجَحاجِحةٌ. قال أمية: ماذا بِبَدْرٍ فالعَقَنْـ *** ـقلِ من مَرازِبةٍ جَحاجِحْ ومن هذا الباب أجَحَّت الأُنثى إذا حَمَلت وأَقْرَبت، وذلك حين يعظُمُ بطْنُها لكِبَر وَلَدِها فيه. والجمع مَجَاحُّ. وفي الحديث: "أنّهُ مَرّ بامرأةٍ مُجِحٍّ". هذا الذي ذكرَهُ الخليل. وزاد ابنُ دريدٍ بعضَ ما فيه نظرٌ، قال: جَحَّ الشيءَ إذا سحَبَه، ثم اعتذر فقال: "لغة يمانية". والجُحُّ: صغار البِطِّيخ. (جخ) الجيم والخاء. ذكر الخليلُ أصلَين: أحدهما التحوُّل، والتنَحِّي، والآخر الصِّياح. فأمّا الأول فقولهم جخّ الرّجلُ يَجِخُّ جخّاً، وهو التحوُّلُ من مكانٍ إلى مكان. قال: وفي الحديث: "أنّه كان إذا صلّى جخَّ"، أي تحوَّلَ من مكان إلى مكان. قال: والأصل الثاني: الجَخْجَخة، وهو الصِّياح والنِّداء. ويقولون: * إنْ سَرَّكَ العِزُّ فجَخْجِخْ في جَشَمْ * يقول: صِحْ ونادِ فيهم. ويمكن أنْ يقول أيضاً: وتحوَّلْ إليهم. وزاد ابنُ دريد: جخّ برِجْلِه إذا نَسَفَ بها التُّراب. وجَخَّ ببوله إذا رغَّى به. وهذا إنْ صحَّ فالكلمة الأولى من الأصل الأول، لأنّه إذا نَسَفَ الترابَ فقد حوَّله من مكانٍ إلى مكان. والكلمةُ الثانيةُ من الأصل الثاني؛ لأنّه إذا رغَّى فلا بد من أنْ يكون عند ذلك صَوْت. وقال: الجخجخة صوت تكسُّر الماء، وهو من ذلك أيضاً. فأمّا قوله جَخْجَخْتُ الرّجلَ إذا صرعْتَه، فليس يبعُدُ قياسه من الأصل الأوّل الذي ذكرناه عن الخليل. (جد) الجيم والدال أصولٌ ثلاثة: الأوَّل العظمة، والثانية الحَظ، والثالث القَطْع. فالأوّل العظمة، قال الله جلّ ثناؤُه إخباراً عمّن قال: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} [الجن 3]. ويقال جَدَّ الرجُل في عيني أي عَظُم. قال أنسُ بنُ مالكٍ: "كان الرجلُ إذا قرأ سورةَ البقرة وآلِ عِمرانَ جَدَّ فينا"، أي عَظُم في صُدورِنا. والثاني: الغِنَى والحظُّ، قال رسول الله صلى الله عليه* وآله وسلم في دعائه "لا يَنْفَع ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ"، يريد لا ينفَعُ ذا الغنى منك غِناه، إنّما ينفعه العملُ بطاعتك. وفلان أجَدُّ من فلانٍ وأحَظُّ منه بمعنىً. والثالث: يقال جَدَدت الشيءَ جَدّاً، وهو مجدودٌ وجَديد، أي مقطوع. قال: أبَى حُبِّي سُلَيْمى أَنْ يَبِيدا *** وأمسَى حبلُها خَلَقاً جَدِيدا وليس ببعيدٍ أنْ يكون الجدُّ في الأمرِ والمبالغةُ فيه من هذا؛ لأنّه يَصْرِمه صَرِيمةً ويَعْزِمُه عزيمة. ومن هذا قولك: أَجِدَّكَ تفعلُ كذا، أي أجدّاً منك، أصريمةً منك، أعَزِيمةً منك. قال الأعشى: أجِدَّكَ لم تسمَعْ وَصاةَ محمّدٍ *** نبيِّ الإلهِ حين أوْصَى وأَشْهَدا وقال: أجِدَّكَ لم تغتمِضْ ليلةً *** فتَرقُدَها مَعَ رُقَّادِها والجُدُّ البِئر من هذا الباب، والقياس واحد، لكنها بضم الجيم. قال الأعشى فيه: ما جعِل الجُدُّ الظَّنُونُ الذي *** جُنِّب صَوْبَ اللَّجِبِ الماطِرِ والبئر تُقْطَع لها الأرضُ قَطْعاً. ومن هذا الباب الجَدْجَدُ: الأرض المستوِية. قال: يَفِيضُ على المرء أردانُها *** كفَيْضِ الأتِيِّ عَلَى الجَدْجَدِ والجَدَدُ مثل الجَدْجدِ. والعربُ تقول: "مَنْ سَلَكَ الجَدَدَ أمِنَ العِثار". ويقولون: "رُوَيْدَ يَعْلُون الجَدَدَ". ويقال أجَدَّ القومُ إذا صارُوا في الجَدَد. والجديد: وَجْهُ الأرض. قال: * إلاّ جَدِيدَ الأرض أو ظَهْر اليدِ * والجُدَّة من هذا أيضاً، وكلُّ جُدّةٍ طريقة. والجُدّة الخُطّة تكون على ظهْر الحِمار. ومن هذا الباب الجَدَّاءُ: الأرض التي لا ماء بها، كأنّ الماءَ جُدّ عنها، أي قطِع ومنه الجَدُود والجَدّاءُ من الضَّان، وهي التي جَفَّ لبنُها ويَبِس ضَرْعُها. ومن هذا الباب الجِداد والجَداد، وهو صِرَام النَّخل. وجادَّةُ الطَّريق سَواؤُه، كأنّه قد قُطِع عن غيره، ولأنه أيضاً يُسْلَك ويُجَدُّ. ومنه الجُدّة. وجانبُ كلِّ شيء جُدّة، نحو جُدَّة المَزَادة، وذلك هو مكان القَطْع من أطرافها. فأمَّا قولُ الأعشى: أضاءَ مِظَلَّتَه بالسِّرا *** جِ واللَّيلُ غامِرُ جُدَّادِها فيُقال إنها بالنَّبطيّة، وهي الخيوط التي تُعْقَد بالخيمة. وما هذا عندي بشيءٍ، بل هي عربيّةٌ صحيحة، وهي من الجَدِّ وهو القَطع؛ وذلك أنَّها تُقطَعُ قِطَعاً على استواءٍ. وقولهم ثوبٌ جديد، وهو من هذا، كأنَّ ناسِجَه قَطَعه الآن. هذا هو الأصل، ثم سمِّي كلُّ شيءٍ لم تأْتِ عليه الأيَّام جديداً؛ ولذلك يسمَّى اللَّيلُ والنهارُ الجديدَينِ والأجَدّين؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما إذا جاءَ فهو جديد. والأصلُ في الجدّة ما قلناه. وأمّا قول الطِّرِمّاح: تَجْتَنِي ثامِرَ جُدَّادِهِ *** مِن فُرادَى بَرَمٍ أو تُؤَامْ فيقال إن الجُدّاد صِغار الشجر، وهو عندي كذا على معنى التشبيه بجُدّاد الخيمة، وهي الخيوط، وقد مضى تفسيره. (جذ) الجيم والذال أصلٌ واحدٌ، إمَّا كَسْرٌ وإمَّا قَطْع. يقال جذَذْت الشيءَ كسرتُه. قال الله تعالى: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إلاّ كَبِيراً لَهُمْ} [الأنبياء 58]، أي كَسَّرهم. وجذَذْتُه قطَعْته، [ومنه] قوله تعالى: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود 108]، أي غير مقطوع. ويقال ما عليه جُذّةٌ، أي شيءٌ يستُره من ثيابٍ، كأنّه أراد خِرقةً وما أشبهها. [و] من الباب الجَذِيذة، وهي الحبُّ يُجَدُّ وَيُجعَل سَوِيقاً. ويقال لِحجارة الذّهب جُذَاذٌ، لأنّها تكَسّر وتحلّ. قال الهذليّ: * كما صَرَفَتْ فَوْقَ الجُذاذِ المَسَاحِنُ * المساحِن: آلات يدقُّ بها حِجارة الذَّهب، واحدتها مِسْحَنَةٌ. فأمَّا المُجْذَوْذِي فليس يبعُد أن يكون من هذا، وهو اللازمُ الرّحْل لا يفارقُه منتصِباً عليه. يقال اجْذَوْذَى؛ لأنّه إذا كان كذا فكأنّه انقطَعَ عن كلِّ شيءٍ وانتصب لسفَره على رَحْله. قال: ألَسْتَ بمُجْذَوْذٍ [على] الرحْلِ دائباً *** فمالك إلاّ ما رُزِقتَ* نصيبُ (جر) الجيم والراء أصلٌ واحد؛ وهو مدُّ الشّيءِ وسَحْبُه. يقال جَرَرت الحبلَ وغيرَه أجُرُّهُ جَرّاً. قال لَقيط: جرّت لما بينَنَا حَبْلَ الشَّمُوسِ فلا *** يأساً مُبيناً نَرَى منها ولا طَمعاً والجَرُّ: أسفَل الجبَل، وهو من الباب، كأنّه شيءٌ قد سُحِب سحْباً. قال: * وقد قَطَعْتُ وَادِياً وَجَرَّا * والجرور من الأفراس: الذي يَمْنَع القِياد. وله وجهان: أحدهما أنّه فعول بمعنى مفعول، كأنّه أبداً يُجرُّ جَرّاً، والوجه الآخر أن يكون جروراً على جهته، لأنه يجرّ إليه قائدهُ جَرّاً. والجرَّار: الجيش العظيم، لأنّه يجرّ أتباعه وينجرّ. قال: سَتَنْدَمُ إذْ يَأتي عليك رعيلُنا *** بأرْعَنَ جَرّارٍ كثيرٍ صواهِلُه ومن القياس الجُرْجُور، وهي القطعة العظيمة من الإبل. قال: * مائةً مِن عَطائِهمْ جُرْجُورَا * والجرير: حبلٌ يكون في عنق النّاقة مِن أَدَم، وبه سمِّي الرّجل جَريراً. ومن هذا الباب الجريرةُ، ما يجرُّه الإنسانُ من ذنبٍ، لأنّه شيءٌ يجرُّه إلى نفسه. ومن هذا الباب الجِرَّة جِرَّة الأنعام، لأنّها تُجَرّ جَرّاً. وسمّيت مَجَرّةُ السماء مجرّةً لأنّها كأثر المَجَرّ. والإجرار: أن يُجرَّ لسانُ الفصيل ثم يُخَلَّ لئلا يَرْتَضِع. قال: * كما خَلَّ ظَهْرَ اللِّسانِ المُجِرّ * وقال قوم الإجرار أن يجرَّ ثم يشق. وعلى ذلك فُسِّر قول عمرو: فلو أنَّ قومِي أنطقَتْني رِماحُهُمْ *** نطَقْتُ ولكنَّ الرِّماحَ أجرَّتِ يقول: لو أنّهم قاتَلُوا لذكرتُ ذلك في شعرِي مفتخِراً به، ولكنّ رماحَهم أجَرّتْني فكأنّها قطعت اللِّسانَ عن الافتخار بهم. ويقال أجَرّهُ الرّمحَ إذا طعَنَه وتَرك الرّمح فيه يَجرّه. قال: * ونجِرُّ في الهيجا الرِّماحَ ونَدّعِي * وقال: وغَادَرْنَ نَضْلَة في مَعْرَكٍ *** يجرُّ الأَسنَّةَ كالمحتَطِبْ وهو مَثَلٌ، والأصل ما ذكرناه مِن جرّ الشيء. ويقال جَرَّتِ الناقةُ، إذا أتت على وقت نِتاجها ولم تُنْتَج إلاّ بعد أيَّام، فهي قد جَرَّتْ حَمْلَها جرّاً. وفي الحديث: "لا صَدَقةَ في الإبِلِ الجارَّة"، وهي التي تُجَرُّ بأزمَّتها وتُقاد، فكأنه أراد التي تكون تحت الأحمال، ويقال بل هي رَكُوبة القوم. ومن هذا الباب أجرَرْتُ فلاناً الدَّينَ إذا أخَّرْتَه به، وذلك مثل إجرار الرُّمح والرَّسَن. ومنه أجَرّ فلانٌ فلاناً أغانِيَّ، إذا تابَعَها له. قال: فلما قَضَى مِنِّي القَضاءَ أجرَّني *** أغانِيَّ لا يَعيَا بهَا المُتَرَنِّمُ وتقول: كان في الزَّمَن الأوّل كذا وهلُمَّ جرّاً إلى اليوم، أي جُرَّ ذلك إلى اليوم لم ينقَطعْ ولم ينصَرِمْ. والجَرُّ في الإبل أيضاً أن تَرْعَى وهي سائرةٌ تجرّ أثقالها. والجارُور -فيما يقال- نهرٌ يشقُّه السَّيل. ومن الباب الجُرّة وهي خَشَبة نحو الذِّراع تُجعَل في رأسها كِفَّة وفي وسطها حبل وتُدفَن للظِّباء فتَنْشَب فيها، فإذا نَشِبتْ نَاوَصَها ساعةً يجرُّها إليه وتجرُّه إليها، فإذا غلبَتْه استقرّ [فيها]. فتضرب العرب بها مثلاً للذي يُخالف القومَ في رائِهِمْ ثمّ يرجع إلى قولهم. فيقولون "ناوَصَ الجُرَّةَ ثم سالَمَها". والجَرَّة من الفَخّار، لأنّها تُجَرّ للاستقاء أبداً. والجَرُّ شيء يتّخذ من سُلاخَةِ عُرقوبِ البعير، تَجْعلُ فيه المرأةُ الخَلْع ثم تعلِّقه عند الظَّعْن من مُؤَخَّر عِكْمها، فهو أبداً يتذبذب. قال: زوجُكِ يا ذاتَ الثنايا الغُرِّ *** والرَّتِلاَتِ والجَبينِ الحُرِّ أعْيَا فَنُطْنَاهُ مَنَاط الجَرِّ *** ثم شَدَدْنا فوقَه بِمَرِّ ومن الباب رَكيٌّ جَرور، وهي البعيدة القَعْر يُسْنَى عليها، وهي التي يُجَرُّ ماؤُها جَرّا. والجَرّة الخُبزة تُجرّ من المَلَّة. قال: وصاحبٍ صاحبته خِبٍّ دَنِعْ*** داوَيْتُه لما تشكّى ووَجِعْ بجَرّةٍ مثلِ الحِصانِ المضطجِعْ فأمّا الجرجرة، وهو الصّوت الذي يردِّده* البعير في حَنجرته فمن الباب أيضاً، لأنّه صوتٌ يجرُّه جرّاً، لكنَّه لما تكرَّر قيل جَرْجر، كما يقال صَلَّ وصَلْصَلَ. وقال الأغلب: جَرْجَرَ في حنجرةٍ كالحُبِّ *** وهامَةٍ كالمِرجلِ المنكَبِّ ومن ذلك الحديثُ: "الذي يشرب في آنية الفِضَّة إنما يُجَرْجِرُ في جوفه نارَ جهنم". وقد استمرَّ البابُ قياساً مطّرداً على وجهٍ واحد. (جز) الجيم والزاء أصلٌ واحد، وهو قَطْعُ الشيء ذي القُوَى الكثيرةِ الضعيفة. يقال: جَزَزْتُ الصوف جَزّاً. وهذا زَمَنُ الجَزَازِ والجِزاز. والجَزُوزة: الغنم تُجَزُّ أصوافُها. والجُزازَة: ما سَقَط من الأديم إذا قُطِع. وهذا حملٌ على القياس. والأصل في الجزِّ ما ذكرتُه. والجَزِيزَةُ: خُصْلَةٌ من صُوف، والجمع جَزائز. (جس) الجيم والسين أصلٌ واحد، وهو تعرُّف الشيء بمسٍّ لطيف. يقال جَسَسْتُ العرْق وغَيْرَه جَسّاً. والجاسوس فَاعولٌ من هذا؛ لأنه يتخبَّرُ ما يريده بخَفاءٍ ولُطْفٍ. وذُكر عن الخليل أنَّ الحواسَّ التي هي مشاعرُ الإنسان ربّما سمِّيت جَواسَّ. قال ابنُ دريد: وقد يكون الجسُّ بالعَيْن. وهذا يصحِّح ما قاله الخليل. وأنشد: * فاعْصَوْصَبُوا ثمَّ جَسُّوه بأعيُنهم * (جش) الجيم والشين أصلٌ واحد، وهو التكسُّر، يقال منه جششتُ الحبَّ أجُشُّه. والجَشِيشة: شيءٌ يُطبَخ من الحبِّ إذا جُشَّ. ويقولون في صفة الصَّوت: أجَشُّ؛ وذلك أنّه يتكسَّر في الحلْق تكسُّراً. ألا تراهم يقولون: قَصَب أجشّ مُهَضَّم. ويقال فَرَسٌ أجشُّ الصوت، وسَحابٌ أَجَشّ. قال: بأجَشِّ الصَّوتِ يَعْبُوبٍ إذا *** طُرِقَ الحيُّ مِنَ اللَّيْلِ صَهَلْ فأمّا قولُهم جشَشْتُ البِئْرَ إذا كنَستَها، فهو من هذا، لأنَّ المُخْرَج منها يتكسَّر. قال أبو ذؤيب: يقولون لما جُشَّتِ البئرُ أوْرِدُوا *** وليس بها أدنى ذُِفافٍ لواردِ (جص) الجيم والصاد لا يصلُحُ أن يكون كلاماً صحيحاً. فأمّا الجِصّ فمعرَّب، والعرب تسمّيه القَِصّة. وجَصَّصَ الجِرْوُ، وذلك فَتْحه عينَيْه. والإجّاص. وفي كلّ ذلك نظر. (جض) الجيم والضاد قريبٌ من الذي قبله. يقولون جَضَّضَ عليه بالسَّيف، أي حَمَل. (جظ) الجيم والظاء إنْ صحَّ فهو جنسٌ من الجَفَاء. ورُوِي في بعض الحديث: "أهلُ النَّارِ كلُّ جَظٍّ مُسْتكبر"، وفسّر أنَّ الجَظّ الضّخم. ويقولون: جَظّ، إذا نَكَحَ. وكلُّ هذا قريب بعضُه من بَعض. (جع) الجيم والعين أصلٌ واحدٌ، وهو المكان غيرُ المَرْضِيِّ. قال الخليل: الجعجاع مُناخُ السَّوْء. ويقال للقتيل: تُرِك بجَعجاع. قال أبو قيس بن الأسْلَت: مَنْ يَذُقِ الحربَ يجِدْ طعمَها *** مُرّاً وتتركْهُ بجعجاعِ قال الأصمعيّ: وهو الحَبْس. قال: * إذا جَعْجَعُوا بينَ الإناخَةِ والحَبْسِ * وكتب ابنُ زياد إلى ابن سعد: "أنْ جَعْجِعْ بالحسين عليه السلام" كأنَّه يُريد: ألجِئْهُ إلى مكانٍ خَشِنٍ قلق. وقال قوم: الجعجعة في هذا الموضع الإزعاج؛ يقال جَعْجَعْتُ الإبِلَ، إذا حرَّكتها للإناخة. وقال أبو ذؤيب، في الجعجعة التي تدلُّ على سوءِ المَصْرَع: فأبَدَّهُنّ حُتوفَهُنَّ فهاربٌ *** بِذَمائِه أو باركٌ مُتَجَعْجِعُ (جف) الجيم والفاء أصلان: فالأوّل قولك جَفَّ الشيءُ جُفُوفاً يَجف. والثاني الجُفّ جُفُّ الطَّلْعة، وهو وعاؤُها. ويقال الجُفُّ شيءٌ يُنْقرُ من جذوع النَّخل. والجُفُّ: نِصْفُ قِرْبة يُتَّخذ دلْواً. وأمّا قولُهم للجماعة الكثير من الناس جُفٌّ، وهو في قول النابغة: * في جُفِّ ثَعْلَبَ وارِدِي الأَمرارِ * فهو من هذا، لأنّ الجماعةَ يُنْضَوَى إليها ويُجتَمع، فكأنّها مَجمعُ مَن يأوِي إليها. فأمّا الجَفْجف الأرضُ المرتفِعة فهو من الباب الأوّل؛ لأنها إذا كانت كذا كان أقَلَّ لنَدَاها. وجُفَافُ الطَّير: مكان. *قال الشاعر: فما أبْصَرَ النّارَ التي وضَحَتْ له *** وراءَ جُفَافِ الطَّيرِ إلا تماريا (جل) الجيم واللام أصولٌ ثلاثة: جَلَّ الشّيءُ: عَظُمَ، وجُلُّ الشيء مُعْظَمُه. وجلال الله: عَظَمته. وهو ذُو الجلالِ والإكرام. والجَلَلُ الأمر العظيم. والجِلَّةُ: الإبل المَسَانّ. قال: أو تأخُذَنْ إبِلي إليّ سِلاحَها *** يوماً لجلّتِها ولا أبكارِها
والجُلالة: النّاقة العظيمة. والجَليلة: خلافُ الدَّقيقة. ويقال ما له دقيقة ولا جَليلة، أي لا ناقةَ ولا شاة. وأتيت فلاناً فما أجَلَّني ولا أحْشَاني، أي ما أعطاني صغيراً ولا كبيراً من الجِلَّة ولا من الحاشية. وأدقَّ فلانٌ وأجلَّ، إذا أَعْطَى القليلَ والكثير. [قال]: ألا مَنْ لعينٍ لا تَرَى قُلَلَ الحِمَى *** ولا جبَلَ الرَّيَّانِ إلا استهلَّتِ لَجُوجٍ إذا سحَّت هَمُوعٍ إذا بكَتْ *** بكَتْ فأدقَّتْ في البُكا وأجَلَّتِ يقول: أتَتْ بقليلِ البكاء وكثيرِه. ويقال: فَعَلْت ذاك من جَلالك. قالوا: معناه من عِظَمِك في صَدْرِي. قال كثيِّر: * وإكرامِي العِدَى من جَلاَلِها * والأصل الثاني شيءٌ يشمل شيئاً، مثل جُلِّ الفَرَس، ومثل [المجَلِّل] الغَيْث الذي يجلِّل الأرض بالماء والنَّبات. ومنه الجُلُول، وهي شُرُعُ السُّفُن. قال القطاميّ: في ذِي جُلُولٍ يُقَضِّي الموتَ صاحبُه *** إذا الصَّرارِيُّ مِنْ أهوالِه ارتَسَمَا الواحد جُلٌّ. والأصل الثَّالث من الصّوت؛ يقال سحاب مُجَلْجِلٌ إذا صوَّت. والجُلْجُل مشتقٌّ منه. ومن الباب جَلجلْتُ الشّيءَ في يدي، إذا خلطْتَه ثم ضربتَه. فَجلجَلَها طَورَينِ ثمّ أَمَرَّها *** كما أُرسِلَتْ مَخْشوبةٌ لم تُقَرَّمِ ومحتمل أن يكون جُلجُلانُ السِّمسمِ من هذا؛ لأنه يتجلجل في سِنْفِه إذا يَبِس. وممّا يحمل على هذا قولهم: أصبْتُ جُلْجُلانَ قَلْبِه، أي حبَّةَ قلبه. ومنه الجَُِـلّ قَصَب الزَّرْع؛ لأنّ الريح إذا وقَعَتْ فيه جلجلَتْه. ومحتمل أن يكونَ من الباب الأوّل لغِلَظِهِ. ومنه الجَليل وهو الثُّمام. قال: ألا ليتَ شِعرِي هل أَبِيتَنَّ ليلةً *** بوادٍ وحولي إذخِرٌ وجَليلُ وأما المَجَلَّة فالصَّحيفة، وهي شاذّة عن الباب، إلاّ أنْ تُلحَق بالأوّل؛ لعِظَم خَطَرِ العِلْم وجلالته. قال أبو عبيد: كلُّ كتابٍ عند العرب فهو مَجَلَّة. ومما شذَّ عن الباب الجلّة البَعَْرُ. (جم) الجيم والميم في المضاعف لـه أصلان: الأوّل كثرةُ الشيء واجتماعه، والثاني عَدَم السِّلاح. فالأوّل الجَمُّ وهو الكثير، قال الله جلّ ثناؤه: {ويُحِبُّونَ المَالَ حُبّاً جَمّاً} [الفجر 20]، والجِمام: المِلْءُ، يقال إناءٌ [جَمَّانُ، إذا بلَغَ] جِمامَهُ. قال: أو كماء المثمودِ بعد جِمامٍ *** زَرِمَ الدمعِ لا يَؤُوبُ نَزُورَا ويقال الفرس في جَمَامِه؛ والجَمَام الرَّاحة، لأنّه يكون مجتمعاً غيرَ مضطرب الأعضاء، فهو قياس الباب. والجُمَّة: القَوم يَسْأَلون في الدّيّة، وذلك يتجمَّعون لذلك. قال: * وجُمَّةٍ تَسْأَلُني أعْطَيْتُ * والجميم مجتمعٌ من البُهْمَى. قال: رَعَى بارِضَ البُهْمَى جميماً وبُسْرةً *** وصمعاءَ حَتَّى آنَفَتْها نِصالُها والجُمَّة من الإنسان مُجتمعُ شَعْر ناصيته. والجَمَّة من البئر المكانُ الذي يجتمع ماؤُها. والجَمُوم: البئر الكثيرة الماء، وقد جَمَّتْ جُمُوماً. قال: * يَزِيدُها مَخْجُ الدِّلاَ جُمُومَا * والجَمُومُ من الأفراس: الذي كلما ذهَبَ منه إحضارٌ جاءَه إحضارٌ آخَر. فهذا يدلُّ على الكثْرة والاجتماع. قال النَّمْر بنُ تَولَب: جَمُومُ الشّدِّ شائلةُ الذُّنابى *** تَخالُ بياضَ غُرَّتِها سِراجَا والجُمجمة: جُمجُمَة الإنسان؛ لأنها تجمع قبائلَ الراس. والجمجمة: البئر تُحفَر في السَّبَخَة. وجَمَّ الفرس وأجمَّ إذا تُرك أنْ يُرْكَبَ. وهو من الباب؛ لأنه تَثُوب إليه* قوّتُه وتجتمع. وجَماجِم العرب: القبائل التي تجمع البطون فيُنسَب إليها دونَهم، نحو كَلْب بن وَبْرة، إذا قلت كلبيٌّ واستغنيتَ أن تنسُِبَ إلى شيءٍ من بطونها. والجَمّاء الغَفير: الجماعة من الناس. قال بعضهم: هي البيضةُ بَيْضة الحديد؛ لأنها تجمع شَعرَ الرَّأس. ومن هذا الباب أجَمّ الشيءُ: دنا. والأصل الثاني الأجمّ، وهو الذي لا رُمْحَ معه في الحرب. والشّاة الجمّاءُ التي لا قَرْن لها. وجاءَ في الحديث: "أُمِرْنا أن نبني المساجدَ جُمّاً"، يعني أن [لا] يكون لجدرانها شُرَفٌ. (جن) الجيم والنون أصل واحد، وهو [السَّتْر و] التستُّر. فالجنَّة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة، وهو ثواب مستورٌ عنهم اليومَ. والجَنّة البستان، وهو ذاك لأنّ الشجر بِوَرَقه يَستُر. وناسٌ يقولون: الجَنّة عند العرب النَّخْل الطِّوَال، ويحتجُّون بقول زهير: كأنَّ عَيْنَيّ [في] غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ *** مِن النَّواضح تَسْقِي جَنَّةً سُحُقا والجنين: الولد في بطن أُمّه. والجنين: المقبور. والجَنَان: القَلْب. والمِجَنُّ: الترسُ. وكلُّ ما استُتر به من السِّلاح فهو جُنَّة. قال أبو عبيدةَ: السّلاح ما قُوتِل به، والجُنّة ما اتُّقِيَ به. قال: حيث تَرَى الخيلَ بالأبطال عابِسَةً *** ينْهَضْنَ بالهُنْدُوانيّاتِ والجُنَنِ والجِنّة: الجنون؛ وذلك أنّه يغطِّي العقل. وجَنَانُ الليل: سوادُه وسَتْرُه الأشياءَ. قال: ولولا جَنَان الليل أدْرَكَ ركْضُنا***بذِي الرِّمْث والأرْطَى عِياضَ بنَ ناشِبِ ويقال جُنُون الليل، والمعنى واحد. ويقال جُنَّ النَّبتُ جُنوناً إذا اشتدّ وخَرَج زهره. فهذا يمكن أن يكون من الجُنونِ استعارةً كما يُجنُّ الإنسان فيهيج، ثم يكون أصل الجنون ما ذكرناه من السَّتْر. والقياس صحيح. وجَنَان النّاس مُعْظمُهم، ويسمَّى السَّوَادَ. والمَجَنّة الجنون. فأمّا الحيّة الذي يسمَّى الجانَّ فهو تشبيهٌ له بالواحد من الجانّ. والجنُّ سُمُّوا بذلك لأنهم متستِّرون عن أعيُنِ الخَلْق. قال الله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف 27]. والجناجنِ: عظام الصَّدْر. (جه) الجيم والهاء ليس أصلاً؛ لأنه صوتٌ. يقال جهجهت بالسَّبُع إذا صحتَ به. قال: * فجاء دُونَ الزَّجرِ والتجهجُهِ * وحَكَى ناسٌ: تجهجَهَ عن الأمر انتهى. وهذا إن كان صحيحاً فهو في باب المقابلة؛ لأنك تقول جَهْجَهْتُ به فتجَهْجَهَ. (جو) الجيم والواو شيءٌ واحد يحتوي على شيءٍ من جوانبه. فالجوّ جوّ السماء، وهو ما حَنَا على الأرض بأقطارِهِ، وجَوّ البيت من هذا. وأما الجؤجؤ. وهو الصّدر، فمهموز، ويجوز أن يكون محمولاً على هذا. (جأ) الجيم والهمزة ليس أصلاً لأنه حكايةُ صوت. يقال جَأْجَأْتُ بالإبل إذا دعوتَها للشُّرب. والاسم الجِيء. قال: وما كان على الجِيءِ *** ولا الهِيءِِ امْتِداحِيكا (جب) الجيم والباء في المضاعف أصلان: أحدهما القَطْع، والثّاني تجمُّع الشيء. فأمّا الأول فالجَبُّ القطع، يقال جَبَبْتُه أَجُبُّه جَبّاً. وخَصِيٌّ مجبوبٌ بيِّن الجِبَاب. ويقال جَبَّه إذا غَلَبَه بحُسْنِه أو غيرِه، كأنه قطَعَه عن مُساماتِه ومفاخَرَتِهِ. قال: جَبَّتْ نساءَ العالمينَ بالسَّبَبْ *** فهُنّ بَعْدُ كلهُنَّ كالمحبّ وكانت قدَّرَتْ عجِيزَتَها بحبلٍ وبعثَتْ إليهن: هل فيكنّ مثلُها؟ فلم يكُنْ، فغلبَتْهُنَّ. وهذا مثلُ قول الاخر: لقد أهدَتْ حَبابةُ بِنْتُ جَزْءٍ *** لأهل جُلاجِلٍ حَبْلاً طويلا والجَبَبُ أن يُقطَع سَنام البعير؛ وهو أجبُّ وناقةٌ جَبَّاءُ. الأصل الثاني الجُبَّة معروفة، لأنها تشمل الجِسم وتجمعه فيها. والجُبَّة ما دَخَل فيه ثَعْلب الرُّمح من السِّنان. والجُبْجُبَة: زَبيلٌ من جُلود يُجمَع فيه التُّرابُ إذا نُقِل. والجُبْجُبَة: الكَرِش يُجعَلُ فيه اللَّحم وهو الخَلْعُ. وجَبَّ الناسُ النخل إذا* ألقَحُوه، وذا زمن الجِباب. والجَبُوب: الأرض الغَليظة، سمِّيت بذلك لتجمّعها. قال أبو خراش يصف عقاباً رفَعَتْ صيداً ثم أرسلَتْه فصادَمَ الأرض: فلاقَتْه ببَلْقَعةٍ بَرَاحٍ *** فَصادَمَ بين عينيْهِ الجَبُوبا المَجَبَّةُ: جادَّة الطَّرِيق ومُجْتَمعُهُ. والجُبّ: البئر. ويقال جَبَّبَ تجبيباً إذا فرَّ وذلك أنه يجمع نفسَه للفِرار ويتشمَّر. ومن الباب الجُبَاب: شيءٌ يجتمع من ألبان الإبل كالزُّبد. وليس للإبل زُبْد. قال الراجز: يَعْصِب فَاهُ الرِّيقُ أيَّ عَصْبِ *** عَصْبَ الجُبَابِ بِشفَاهِ الوَطبِ قال ابن دُريدٍ: الجبجاب الماءُ الكثير، وكذلك الجُباجِبُ. (جث) الجيم والثاء يدلّ على تجمُّع الشيء. وهو قياسٌ صحيح. فالجُثَّة جُثَّة الإنسان، إذا كان قاعداً أو نائماً. والجُثّ: مجتمِعٌ من الأرض مرتفِعٌ كالأكَمَة. قال ابنُ دريد: وأحسب أنّ جُثَّة الرجل من هذا. ويقال الجَثُّ قذىً يخالط العَسَل. وهو الذي ذكره الهذلي: فما بَرِحَ الأسبابُ حَتَّى وَضَعْنَه *** لَدَى الثَّوْلِ ينفي جثَّها ويؤُومُها ويقال: الجَثُّ الشَّمع. والقياس واحد. ويقال نَبْتٌ جُثاجِثٌ كثيرٌ. ولعلَّ الجَثجاثَ مِن هذا. وجُثِثْتُ من الرَّجل إذا فزِعْتَ، وذلك أنّ المذعور يتجمّع. فإن قالَ قائل: فكيف تقيس على هذا جَثثْت الشيءَ واجتثَثْته إذا قلعتَه، والجَثِيث من النَّخل الفَسيل، والمِجَثَّة الحديدة التي تَقتلِعُ بها الشيء؟ فالجواب أنّ قياسَه قياسُ الباب؛ لأنه [لا] يكون مجثوثاً إلاّ وقد قُلِع بجميع أصوله وعُروقه حتّى لا يُترَك منه شيءٌ. فقد عاد إلى ما أصَّلناه.
(جحد) الجيم والحاء والدال أصلٌ يدلُّ على قِلّة الخير. يُقال عامٌ جَحِدٌ قليل المطر. ورجل جَحِْدٌ فقير، وقد جَحِدَ وأَجْحَدَ. قال ابن دُريد: والجَحْد من كلِّ شيءٍ القِلّة. قال الشاعر: * ولَنْ يَرَى ما عاش إلاّ جَحْدا * وقال الشيباني:[أجحَدَ الرّجلُ وجحدا إذا أنفَضَ وذهبَ مالُه. وأنشد للفرزدق]: وبيضاء من أهل المدينة لم تذق *** بَئِيساً ولم تتبعْ حُمُولَةَ مُجْحِدِ ومن هذا الباب الجُحود، وهو ضدّ الإقرار، ولا يكون إلاّ مع علم الجاحد به أنّه صحيح. قال الله تعالى: {وَجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل 14]. وما جاء جاحدٌ بخيرٍ قطّ. (جحر) الجيم والحاء والراء أصلٌ يدلّ على ضِيق الشيء والشدّة. فالجِحَرة جمع جُحْر. [وأجحَرَ] فلاناً الفَزَعُ والخوفُ، إذا ألجأَه. ومَجاحِرُ القومِ مَكامِنهم. وجَحَرَتْ عينُه إذا غَارَت. والجَحْرة: السَّنَة الشديدة. (جحس) الجيم والحاء والسين ليس أصلاً. وذلك أنّهم قالوا: الجِحاس، ثم قالوا: السِّين [بدل] الشين. قال ابن دريد: جُحِسَ جلدُه مثل جُحِش، إذا كُدِح. (جحش) الجيم والحاء والشين متباعدةٌ جدّاً. فالجحش معروفٌ. والعرب تقول: "هو جُحَيشُ وَحْدِهِ" في الذّم، كما يقولون: "نَسِيج وَحْدِه" في المدح. فهذا أصلٌ. وكلمةٌ أخرى، يقولون: جُحِش إذا تقشّر جلده. وفي الحديث: "أنه صلى الله عليه وآله وسلم سَقَط من فَرَسٍ فجُحِشَ شِقُّهُ". وكلمةٌ أخرى: جاحَشْتُ عنه إذا دافَعْتَ عنه. ويقال نَزَل فلانٌ جحيشاً. وهذا من الكلمة التي قبله، وذلك إذا نزلَ ناحيةً من الناس. قال الأعشَى: * إذا نَزَل الحيُّ حَلَّ الجَحِيشٌ * وأمّا الجَحْوَشُ، وهو الصبيُّ قبل أن يشتدّ، فهذا من باب الجَحْش، وإنّما زيد في بنائه لئلا يسمَّى بالجَحْش، وإلاّ فالمعنى واحدٌ. قال: قَتَلْنَا مَخْلَداً وابنَيْ حُراقٍ *** وآخَرَ جَحْوشاً فوق الفَطِيم (جحظ) الجيم [والحاء] والظاء كلمةٌ واحدة: جحظت العينُ إذا عظُمَتْ مُقْلَتها وبرزَتْ. (جحف) الجيم والحاء والفاء [أصلٌ] واحدٌ، قياسُه الذَّهاب بالشّيء مُسْتَوْعَباً. يقال* سَيْل جُحَافٌ إذا جَرَف كلَّ شيءٍ وذهَبَ به. قال: لها كَفَلٌ كصَفَاةِ المَسيلِ *** أبْرَزَ عنها جُحَافٌ مُضِرّ وسمِّيت الجُحْفة لأنَّ السيّلَ جَحَفَ أهلَها، أي حَمَلَهم. ويقال أجْحَفَ بالشَّيء إذا ذَهَبَ به. وموتٌ جُحافٌ مثل جُراف. قال: * وكم زَلَّ عنها من جُحافِ المَقَادِرِ * ومن هذا الباب الجُحاف: داءٌ يصيب الإنسانَ في جوفه يُسْهِلُهُ، والقياس واحد. وجَحفْت له أي غَرَفْتُ. وأصلٌ آخر، وهو المَيْل والعُدول. فمنها الجِحَاف وهو أنْ يُصيب الدّلوُ فَمَ البئر عند الاستقاء. قال: * تَقْوِيمَ فَرْغَيْها عن الجِحافِ * وتجاحَفَ القومُ في القتال: مالَ بعضُهم على بعضٍ بالسُّيوف والعِصِيّ. وجاحَفَ الذَّنْبَ إذا مالَ إليه. وفلان يُجْحِف لِفُلانٍ: إذا مال معه على غيره. (جحل) الجيم والحاء واللام يدلُّ على عِظَم الشّيء. فالجَحْل السِّقاءُ العظيم. والجَيْحَل: الصّخرة العظيمة. والجَحْل: اليعسوب العظيم. والجَحْلُ: الحِرْباء. قال ذو الرّمة: فلما تَقَضَّتْ حاجةً مِن تحمُّل *** وأَظْهَرْنَ واقْلَوْلَى على عُودِه الجَحْلُ وأمّا قولُهم جَحَّلت الرَّجلَ صرعْتُه فهو من هذا؛ لأنّ المصروع لا بد أن يتحوّز ويتجمَّع. قال الكميت: ومالَ أبو الشَّعثاء أشعَثَ دامياً *** وأنَّ أبا جَحْلٍ قتيلٌ مُجَحَّلُ ومما شذَّ عن الباب الجُحَال، وهو السمُّ القاتل. قال: * جرَّعَهُ الذَّيْفَانَ والجُحالاَ * (جحم) الجيم والحاء والميم عُظْمُها به الحرارةُ وشدَّتُها. فالجاحم المكان الشديدُ الحرّ. قال الأعشى: يُعِدُّون للهيجاء قبلَ لِقائها *** غَداةَ احتضارِ البأْسِ والموتُ جاحمُ وبه سُمِّيت الجحيمُ جحيماً. ومن هذا الباب وليس ببعيدٍ منه الجَحْمة العَيْن، ويقال إنّها بلغة اليمن. وكيف كان فهي من هذا الأصل؛ لأن العينين سِراجانِ متوقِّدان. قال: أيا جَحْمَتِي بَكِّي على أمّ عامِرٍ *** أكيلةِ قِلَّوْبٍ بإحدى المَذَانبِ قالوا: جَحْمَتَا الأسدِ عيناه في اللغات كلِّها. وهذا صحيح؛ لأنّ عينيه أبداً متوقدتان. ويقال جَحَّم الرّجل، إذا فتح عينيه كالشَّاخص، والعينُ جاحمة. والجُحام: داءٌ يصيب الإنسانَ في عينيه فتَرِمُ عيناه. والأجحم: الشديدُ حمرةِ العين مع سَعتها، وامرأةٌ جحماء. وجَحَّمني بعينه إذا أحَدَّ النّظر. فأما قولهم أجْحَم عن الشيء: إذا كعّ عنه فليس بأصل، لأن ذلك مقلوبٌ عن أحجَم. وقد ذُكر في بابه. (جحن) الجيم والحاء والنون أصلٌ واحد، وهو سوء النَّماء وصِغَرُ الشيء في نفسه. فالجَحَن سوءُ الغذاء، والجَحِن السّـيّئ الغِذاء. قال الشماخ: وقد عَرِقَتْ مغابنُها وجادت *** بدِرَّتِها قِرَى جَحِنٍ قَتِينِ القتين: القليل الطُّعْم. يصف قُرَاداً، جعله جَحِناً لسوء غذائه. والمُجْحَن من النّبات: القصير الذي لم يتمّ. وأما [جَحْوَانُ فاشتقاقُه من] الجَحْوةِو [هي] الطَّلْعة.
(جخر) الجيم والخاء والرَّاء: قُبْحٌ في الشيء إذا اتسع. يقولون جَخَّرْنا البئرَ وسَّعْناها. والجَخَرُ ذَمٌّ في صفة الفم، قالوا: هو اتِّساعُه، وقالوا تغيُّرُ رائحتِهِ. (جخف) الجيم والخاء والفاء كلمةٌ واحدة، وهو التكبُّر، يقال: فلان ذو جَخْفٍ وجَخيفٍ إذا كان متكبِّراً كثير التوعُّد. يقولون: جَخَفَ النائم إذا نَفَخَ في نومه. والله أعلم.
(جدر) الجيم والدال والراء أصلان، فالأوّل الجِدار، وهو الحائط وجمعه جُدُر وجُدْران. والجَدرُ أصل الحائط. وفي الحديث: "اسْقِ يا زُبيرُ ودَعِ الماء يرجع إلى الجَدْر". وقال ابن دريد: الجَدَرَةُ حيٌّ من الأزْدِ بنوا جدار الكعبة. ومنه الجَديرة، شيءٌ يُجعَل للغنم كالحظيرة. وجَدَر: قرية. قال: ألا يا اصْبَحينا فَيْهَجاً جَدَرِيَّةً *** بماءِ سحابٍ يَسْبِقُ الحقَّ باطِلي ومن هذا الباب قولهم هو جديرٌ بكذا، أي حريٌّ به. وهو مما ينبغي أن يثبت ويبني أمرَه عليه. ويقولون: الجديرة الطبيعة. والأصل الثاني ظُهور الشيء، نباتاً وغيره. فالجُدَرِيُّ معروف، وهو الجَدَرِيُّ أيضاً. ويقال شاةٌ جَدْراءُ إذا كان بها ذاك، والجَدَر: سِلْعَةٌ تظهر في الجسد. والجَدْر النبات، يقال: أجْدَرَ المكانُ وجَدَرَ، إذا ظهر نباته. قال الجَعْدِي: قد تستحِبُّونَ عند الجَدْر أنَّ لكم *** مِنْ آلِ جَعْدَةَ أعماماً وأخوالا والجَدْرُ: أثر الكَدْمِ بعُنق الحمار. قال رؤبة: * أو جادرُ اللِّيتَيْنِ مَطْوِيُّ الحَنَقْ * وإنما يكون من هذا القياس لأنّ ذلك يَنْتَأُ جلدُه فكأنَّه الجُدَرِيّ. (جدس) الجيم والدال والسين. كلمةٌ واحدة وهي الأرض الجادسة التي لا نبات فيها. (جدع) الجيم والدال والعين أصلٌ واحد، وهو جنسٌ من القَطْع يقال جَدَع أنفَه يَجْدَعُهُ جَدْعاً. وجَدَاع: السَّنة الشديدة؛ لأنها تذهبُ بالمال، كأنها جدعته. قال: لقد آلَيْتُ أغْدِرُ في جَدَاعِ *** وإنْ مُنِّيتُ أُمَّاتِ الرّباعِ والجَدِع: السيئ الغِذاء، كأَنه قُطع عنه غذاؤه. قال: وذاتُ هِدْمٍ عارٍ نواشِرُها *** تُصْمِتُ بالماء تولَبَاً جَدِعَا ويقولون: جَادَعَ فلانٌ فلاناً، إذا خاصَمَه. وهذا من الباب، كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يروم جَدْعَ صاحِبِه. ويقولون: "تركْتُ أرْضَ بني فُلانٍ تَجَادَعُ أفاعِيها". والمجَدَّع من النبات: ما أُكِل أعْلاه وبقي أسفلُه. وكلأ جُدَاع: دَوٍ، كأنَّه يَجْدَعُ مِنْ رَدَاءَته ووَخامته. قال: * وغِبُّ عَدَاوَتي كَلأٌ جُداعُ * ومما شذَّ عن الباب المجدُوع المحبوس في السِّجن. [(جدف) ] الجيم والدال والفاء كلماتٌ كلُّها منفردةٌ لا يقاس بعضها ببعض، وقد يجيء هذا في كلامهم كثيراً. فالمِجْداف مِجداف السَّفينة. وجناحا الطائرِ مجدافاه. يقال من ذلك جَدَف الطّائرُ إذا ردّ جناحَيه للطيران. وما أبْعَدَ قياسَ هذا من قولهم إنّ الجُدَافَى الغنيمة، [و] من قولهم إنّ التجديف كُفْران النِّعمة. وفي الحديث: "لا تجَدّفُوا بنعمة الله تعالى"،أي تَحْقِرُوها. (جدل) الجيم والدال واللام أصلٌ واحدٌ، وهو من باب استحكام الشيء في استرسالٍ يكون فيه، وامتدادِ الخصومة ومراجعةِ الكلام. وهو القياس الذي ذكرناه. ويقال للزّمام المُمَرِّ جَديل. والجَدْوَل: نهر صغيرٌ، وهو ممتدٌّ، وماؤُه أقْوى في اجتماع أجزائه من المنبطح السائح. ورجلٌ مجدولٌ، إذا كان قَضِيف الخِلْقة من غير هُزَال. وغلام جادِلٌ إذا اشتدّ. والجُدُول: الأعضاء، واحدها جَدِْل. والجادل من أولاد الإبل: فوق الرَّاشح. والدِّرع المجدولة: المحكمة العَمَل. ويقال جَدَلَ الحَبُّ في سُنْبُله: قَوِيَ. والأجدَل: الصَّقر؛ سمِّي بذلك لقوّته. قال ذو الرمة يذكر حَميراً في عَدْوِها: كأنَّهُنَّ خوافي أجدَلٍ قَرِمٍ *** وَلَّى ليسبِقَه بالأمْعَزِ الخَرَبُ الخَرَبُ: الذّكَر من الحبارى. أراد: ولّى الخَرَب ليسبِقَه ويطلبه. ومن الباب الجَدَالة، هي الأرض، وهي صُلْبة. قال: قد أركب الآلةَ بَعْدَ الآلَهْ *** وأترُكُ العاجزَ بالجَدالهْ ولذلك يقال طعَنَه فجدّلَه، أي رماه بالأرض. والمِجْدل: القَصْر، وهو قياسُ الباب. قال: في مِجْدَلٍ شُيِّدَ بنيانُهُ *** يَزِلُّ عنه ظُفُرُ الطائرِ والجَدَال: الخَلال، الواحدة جَدالة، وذلك أنّه صُلْبٌ غير نضيجٍ، وهو في أوّل أحواله إذا كان أخضَرَ. قال: * يخِرُّ على أيدي السُّقَاة جدَالُها * وجَدِيلٌ: فحلٌ معروف. قال الرّاعي: * صُهْباً تُناسِبُ شَدْقماً وجَدِيلاً * (جدم) الجيم والدال والميم يدلّ على القماءة والقِصَر. رجل جَدَمةٌ، أي قصير. والشاة الجَدَمة: الرّدِيّة القَمِيئة. (جدو/ي) الجيم والدال والحرف المعتل خمسة أصول متباينة. فالجَدَا مقصور: المطر العامّ، والعطيّة الجزْلة. ويقال أجديت عليه. والجَدَاءُ ممدود: الغَنَاء، وهو قياس ما قبله من المقصور. قال: لَقَلَّ جَداءً على مالك *** إذا الحربُ شُبَّت بأجذَالها والثاني: الجَادِيُّ: الزَّعفران. والثالث: الجَدْي، معروف. والجَِدَايَة: الظّبية. والرابع: الجَدِيَّة القِطعة من الدم. والخامس جديتا السّرج، وهما تحت دفَّتيه. (جدب) الجيم والدال والباء أصلٌ واحدٌ يدل على قلّة الشيء. فالجدب: خِلاف الخِصْب، ومكانٌ جدِيبٌ. ومن قياسه الجَدْبُ، وهو العَيْب والتنقُّص. يقال جدَبْتُه إذا عِبْتَه. وفي الحديث: "جدَبَ لهم السَّمَرَ بعد العِشاء"، أي عابه. قال ذو الرمة: فيا لكَ مِنْ خدٍّ أسيلٍ وَمنطقٍ *** رخيمٍ ومِن خَلْقٍ تَعَلّلَ جادبُهْ أي إنه تعلَّلَ بالباطل لمّا لم يجدْ إلى الحقِّ سبيلا. (جدث) الجيم والدال والثاء كلمةٌ واحدة: الجَدَث القَبْر، وجمعه أجداث. (جدح) الجيم والدال والحاء أصلٌ واحدٌ، وهي خشبةٌ يُجْدح بها الدَّواء، [لها] ثلاثة أعيار. والمجدوحُ: شيءٌ كان يُشْرَب في الجاهلية، يُعْمَد إلى الناقة فتفْصَد ويُؤخَذُ دمُها في الإناء، ويشرب ذلك في الجَدْب. والمِجْدَح والمُجْدَح: نجم، وهي ثلاثةٌ كأنها أثافيّ. والقياس واحدٌ. قال: * إذا خَفَق المجْدَحُ * والمِجْدح: مِيسَمٌ من مواسم الإبل على هذه الصورة، يقال أجْدَحْت البَعير إذا وسمتَه بالمجْدَح.
(جذر) الجيم والذال والراء أصلٌ واحدٌ، وهو الأصل من كلِّ شيء، حتى يقالُ لأصلِ اللسانِ جِذْر. وقال حُذَيفة: حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "أنّ الأمانةَ نزلَتْ في جَِذْر قُلوب الرِّجال". قال الأصمعيّ: الجَذْر الأصل من كلِّ شيءٍ. قال زهير: وسامعتَينِ تعرِفُ العِتْقَ فيهما *** إلى جَِذْرِ مَدْلُوكِ الكُعوب مُحدَّدِ
وفي الكتاب المنسوب إلى الخليل: الجَذْر أصل الحِساب، ويقال [عشرة] في عشرة مائة. فأمّا المجذُور والمجذَّر فيقال إنه القصير. وإنّ صح فهو من الباب كأنَّه أصلُ شيءٍ قد فارقه غيره. (جذع) الجيم والذال والعين ثلاثة أصول: أحدها يدلُّ على حدوث السّنّ وطراوته. فالجَذَع من الشّاءِ: ما أتى له سنتانِ، ومن الإبل الذي أتَتْ له خَمْسُ سنينَ. ويُسَمّى الدّهر الأزْلَمَ الجَذَع، لأنه جديد. قال: يا بِشْرُ لو لم أكُنْ منكم بمنزلةٍ *** ألقَى عليَّ يديهِ الأزْلَمُ الجَذَعُ وقال قوم: أراد به الأسد. ويقال: هو في هذا الأمر جَذَعٌ، إذا كان أخَذَ فيه حديثاً. والأصل الثاني: جِذْع الشَّجرة. والثالث: الجَذْع، من قولك جذَعْتُ الشيءَ إذا دلكتَه. قال: * كأنّه مِن طُولِ جَذْع العَفْسِ * وقولهم في الأمثال: "خُذْ من جِذْع ما أعطاك" فإنه [اسم رجل]. (جذف) الجيم والذال والفاء كلمةٌ واحدة تدلّ على الإسراع والقَطْع، يقال جَذَفْتُ الشيءَ قطعتُه. قال الأعشى: قاعداً عندَه النَّدامى فما يَنْـ *** فَكُّ يؤتَى بِمُوكَرٍ مَجْذُوفِ ويقال هو بالدَّال. ويقال جَذَف الرّجُلُ أسرَعَ. قال ابن دريد: جَذَف الطائر إذا أسرَعَ* تحريكَ جناحَيْه. وأكثر ما يكون ذلك أن يُقَصَّ أحدُ جناحيه. ومنه اشتقاق مِجْداف السفينة. قال: وهو عربيٌّ معروف. قال: تكاد إن حُرِّك مجذافُها *** تنْسَلُّ مِنْ مَثْناتِها واليَدِ يعني الناقةَ. جعل السَّوط كالمجذاف لها، وهو بالذال والدال لغتان فصيحتان. (جذل) الجيم والذال واللام أصلٌ واحد، وهو أصل الشيء الثابت والمنتصب. فالجِذْل أصل الشَّجرة. وأصل كلِّ شيءٍ جِذْلُهُ. قال حُبَابُ بنُ المنذِر، لما اختَلَف الأنصارُ في البَيْعة: "أنا جُذَيلُها المحكَّك". وإنّما قال ذلك لأنه يُغْرَزُ في حائطٍ فتحتكُّ به الإبلُ الجَرْبَى. يقول: فأنا يُسْتَشْفى برأْيِي كاستشفاء الإبل بذلك الجِذْل. وقال: * لاقت على الماءِ جُذَيلاً واتدا * يريد أنّه منتصبٌ لا يبرح مكانَه، كالجذل الذي وَتَد، أي ثبت. وأمّا الجََذَل وهو الفرح فممكنٌ أن يكون من هذا؛ لأنّ الفَرِحَ منتصبٌ والمغمومَ لاطِئٌ بالأرض. وهذا من باب الاحتمال لا التحقيق والحُكْم. قالوا: والجِذْل ما بَرَزَ وظَهَرَ من رأس الجبل، والجمع الأجذال. وفلانٌ جِذْلُ مالٍ، وإذا كان سائِساً له. وهو قياس الباب، كأنّه في تفقُّده وتعهُّده له جِذْلٌ لا يبرح. (جذم) الجيم والذال والميم أصلٌ واحدٌ، وهو القطع. يقال جَذَمْت الشَّيء جذْماً. والجِذْمة القِطعة من الحَبْل وغيره. والجُذام سُمِّي لتقطُّع الأصابع. والأجذم: المقطوع اليد. وفي الحديث: "مَن تعلَّم القرآنَ ثُمَّ نسِيَهُ لقِيَ الله تعالى وهو أجذم". وقال المتلمِّس: وما كنتُ إلاّ مثلَ قاطع كفِّه *** بكفٍّ لـه أخْرَى فأصبَحَ أجْذَما وانْجَذَم الحبلُ: انقطَعَ. قال النابغة: بانَتْ سُعادُ فأمسى حَبْلُها انْجَذَما *** واحْتَلّت الشَّرْعَ فالخْبْتَيْنِ مِنْ إضَما والإجذام: السُّرعة في السَّير، وهو من الباب. والإجذام: الإقلاع عن الشيء. (جذو) الجيم والذال والواو أصلٌ يدلّ على الانتصاب. يقال جَذَوْتُ على أطراف أصابعي، إذا قمت. قال: إذا شِئْتُ غَنَّتَنِي دَهَاقِينُ قريةٍ *** وصَنَّاجَةٌ تَجْذُو على حدِّ مَنْسِِمِ قال الخليل: يقال جَذَا يجذُو، مثل جثا يجثُو، إلاّ أنّ جذا أَدَلُّ على اللزوم. وهذا الذي قاله الخليل فدَليلٌ لنا في بعض ما ذكرناه من مقاييس الكلام. والخليل عندنا في هذا المعنى إمامٌ. قال: ويقال جَذَا القُرادُ في جنْب البعير؛ لشدّة التزاقه. وجَذَتْ ظَلِفَة الإكاف في جَنْب الحمار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَثَلُ المنافِق مَثَلُ الأَرْزَة المُجْذِيَة على الأرض حتّى يكونَ انجعافُها مَرَّةً". أراد بالمجْذِيَةِ الثّابتة. ومن الباب تجاذَى القومُ الحَجرَ، إذا تشاوَلُوه. فأمّا قولهم رجلٌ جاذٍ، أي قصير الباع، فهو عندي من هذا؛ لأنّ الباع إذا لم يكن طويلاً ممدوداً كان كالشيء الناتئ المنتصب. قال: إنّ الخلافةَ لم تكن مقصورةً *** أبداً على جاذِي اليدينِ مُبَخَّلِ
(جذب) الجيم والذال والباء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على بَتْرِ الشّيء. يقال جَذَبْتُ الشَّيْءَ أجذبُه جذْباً. وجذَبتُ المُهر عن أمّه إذا فطمتَه، ويقال ناقة جاذب، إذا قلَّ لبنها، والجمع جواذب. وهو قياس الباب؛ لأنه إذا قل لبنها فكأنها جَذبته إلى نفسها. وقد شذّ عن هذا الأصل الجَذَب، وهو الجُمَّار الخَشِن، الواحد جَذَبة.
(جرز) الجيم والراء والزاء أصلٌ واحد، وهو القطْع. يقال جَرَزْتُ الشيءَ قطعتُه. وسيفٌ جُرَاز أي قَطّاع. وأرضٌ جُرُزٌ لا نَبْت بها. كأنَّه قُطِع عنها. قال الكسائي* والأصمعيّ: أرضٌ مجروزة من الجرز، وهي التي لم يُصِبْها المطر، ويقال هي التي أُكل نباتُها. والجَرُوزُ: الرّجُل الذي إذا أكل لم يترُكْ على المائدةِ شيئاً، وكذلك المرأةُ الجَرُوزُ، والنّاقةُ. قال: * تَرَى العَجُوزَ خَِبَّةً جَرُوزَا * والعرب تقول في أمثالها: "لن ترضى شانِئةٌ إلاّ بجَرْزة، أي إنّها مِن شِدّة بَغضائها وحسَدها لا ترضى للذين تُبغِضُهم إلاّ بالاستئصال. والجارز: الشديد من السُّعال، وذلك أنّه يقطَع الحَلْق. قال الشمّاخ: * لها بالرُّغامَى والخياشيمِ جارزُ * ويقال أرضٌ جارِزةٌ: يابسة غليظة يكتنفها رَمْل. وامرأةٌ جارِزٌ عاقر. فأمّا قولهم ذو جَرَزٍ إذا كان غليظاً صُلْباً، وكذلك البعيرُ، فهو عندي محمولٌ على الأرض الجارزة الغليظة. وقد مضى ذِكرُها. (جرس) الجيم والراء والسين أصلٌ واحد، وهو من الصَّوت، وما بعد ذلك فمحمول عليه. قالوا: الجَرْس الصَّوت الخفيّ، يقال ما سمعت لـه جَرْساً، وسمِعتُ جَرْسَ الطّير، إذا سمعتَ صوتَ مناقيرها على شيء تأكله. وقد أجْرَسَ الطائر. ومما حُمِل على هذا قولهم للنَّحل جوارس، بمعنى أواكِل، وذلك أنّ لها عند ذلك أدنى شيءٍ كأنه صوت. قال أبو ذؤيبٍ يذكر نَحْلا: يَظَلُّ على الثَّمراءِ منها جَوَارسٌ *** مَرَاضيعُ صُهْبُ الرّيش زُغبٌ رِقابُها والجَرَس: الذي يعلَّق على الجِمال. وفي الحديث: "لا تصحبُ الملائكةُ رُِفْقَةً فيها جَرَسٌ". ويقال جَرَسْتُ بالكلام أي تكلّمتُ به. وأجْرَسَ الحَلْيُ: صوَّت. قال: تَسْمَعُ لِلحَلْيِ إذا ما وَسْوَسَا *** وارتجَّ في أجْيَادها وأجْرَسا ومما شذَّ عن هذا الأصل الرجل المجرّس وهو المجرّب. ومعنى جَرَْسٌ من الليل، أي طائفة. (جرش) الجيم والراء والشين أصلٌ واحد وهو جَرْش الشَّيء: أنْ يُدقَّ ولا يُنْعَم دَقُّه. يقال جَرَشْته، وهو جَرِيش. والجُرَاشة: ما سقط من الشيءِ المجروش. وجرّشت الرأس بالمشط: حككته حتَّى تَستكثِرَ الإبْرِيَة. وذكر الخليل أنّ الجَرش الأكْل. ومما شذَّ عن الباب الجِرِشَّى، وهو النَّفس. قال: * إليه الجِرِشَّى وارْمَعَلَّ حَنِينُها * فأمّا قولهم مَضَى جَرْشٌ من اللّيل، فهي الطائفة، وهو شاذٌّ عن الأصل الذي ذكرناه. قال: * حتى إذا [ما] تُرِكَتْ بجَرْشِ * (جرض) الجيم والراء والضاد أصلانِ: أحدهما جنسٌ من الغَصَص، والآخر من العِظَم. فأمّا الأوّل فيقولون جَرِضَ بِرِيقه إذا اغتصَّ به. قال: كأنّ الفتى لم يَغْنَ في النَّاسِ ليلةً *** إذا اختَلَفَ اللَّحْيانِ عند الجَرِيضِ قال الخليل: الجَرَضُ أن يبتلع الإنسانُ ريقَه على همٍّ وحزْنٍ. ويقال: مات فلانٌ جَرِيضاً، أي مغموماً. والثاني قولهم بعيرٌ جِرْوَاضٌ، أي غليظ. والجُرائِض: البعير الضَّخم، ويقال الشّديد الأكل. ونعجة جُرَئِضةٌ ضَخْمة. (جرع) الجيم والراء والعين يدلّ على قلّة الشيء المشروب. يقال: جَرِع الشاربُ الماءَ يجرَعُه، وجَرَعَ يجرَعُ. فأمَّا [الجرعاء فـ] الرَّملة التي لا تُنبت شيئاً، وذلك من أنّ الشُّرب لاينفَعُها فكأنَّها لم تَرْوَ. قال ذو الرمّة: أمَا استَحْلَبَتْ عينَيْكَ إلاَّ مَحَلَّةٌ *** بجُمْهُورِ حُزْوَى أم بجرعاءِ مالكِ ومن الباب قولهم: "أفْلَتَ فلانٌ بجُرَيْعَة الذَّقَن"، وهو آخِرُ ما يخرُجُ من النَّفَس. كذا قال الفرّاء. ويقال نُوقٌ مَجَارِيعُ: قليلات اللَّبن، كأنّه ليس في ضُروعها إلا جُرَعٌ. ومما شذّ عن هذا الأصل الجَرَع: التواءٌ في قوَّةٍ من قُوَى الحَبْل ظاهرةٍ على سائر القُوَى. (جرف) الجيم والراء والفاء أصلٌ واحدٌ، هو أخْذ الشيءِ كلِّه هَبْشاً. يقال: جَرَفْتُ الشيءَ جَرْفاً، إذا ذهبْتَ به كلِّه. وسيفٌ جُرَافٌ يُذْهِبُ كلَّ شيء. والجُرُْف المكان يأكله السيل. وجَرَّفَ الدهرُ مالَه*: اجتاحه. ومال مُجَرَّف. ورجل جُرَافٌ نُكَحَةٌ، كأنّه يجرِف ذلك جرْفاً. ومن الباب: الجُرْفَة: أنْ تُقَْطَع من فخذِ البعير جلدَةٌ وتُجْمَع على فَخِذه. (جرل) الجيم والراء واللام أصلان: أحدهما الحجارة: والآخر لونٌ من الألوان. فالأول الجَرْوَل والجرَاوِل الحجارة. يقال: أرض جَرِلةٌ، إذا كانت كثيرةَ الجراول. والأَجْرَال جمع الجَرَل، وهو مكان ذو حجارة. قال جرير: مِن كلِّ مشترِفٍ وإنْ بَعُدَ المَدَى *** ضَرِمِ الرِّفاقِ مُناقِلِ الأَجْرَالِ
والآخَر الجِرْيال، وهو الصِّبْغ الأحمر؛ ولذلك سميت الخمر جِرْيالاً. فأما قول الأعشى: وسَبيئةٍ مِمّا تُعَتِّقُ بابِلٌ *** كدَمِ الذَّبيحِ سلبتُها جِرْيالَها فقال قومٌ: أراد لونَها، وهي حمرتها. رووا عنه في ذلك روايةً تدلُّ على أنّه أراد لونَها. (جرم) الجيم والراء والميم أصلٌ واحد يرجع إليه الفروع. فالجرْمُ القطْع. ويقال لِصَِرام النَّخل الجَِرَام. وقد جاءَ زمن الجَِرَامِ. وجَرَمْتُ صُوف الشَّاةِ وأخذته. والجُرَامةُ: ما سقطَ من التّمْرِ إذا جُرِم. ويقال الجُرامة ما التُقِط من كَرَبِهِ بعد ما يُصْرَمُ. ويقال سنة مجَرَّمَةٌ، أي تامّة، كأنها تصرَّمَت عن تمام. وهو من تجرَّم الليلُ ذَهَب. والجَرَام والجَريم: التَّمْر اليابس. فهذا كلُّه متّفقٌ لفظاً ومعنىً وقياساً. ومما يُردّ إليه قولهم جَرَم، أي كَسَب؛ لأن الذي يَحُوزُه فكأنه اقتطَعَه. وفلانٌ جَرِيمةُ أهله، أي كاسِبُهم. قال: جَريمةَ ناهضٍ في رَأسِ نِيقٍ *** تَرَى لِعظامِ ما جَمَعَتْ صَلِيبا يصف عقاباً. يقول: هي كاسِبَةُ ناهضٍ. أراد فرخَها. والجُرْم والجَريمة: الذَّنْب وهو من الأوَّل؛ لأنه كَسْبٌ، والكَسْب اقتطاع. وقالوا في قولهم "لا جَرَم": هو من قولهم جَرَمْتُ أي كسَبت. وأنشدوا: ولقد طعنتُ أبا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً *** جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَها أن يَغْضَبُوا أي كَسَبَتْهُمْ غضباً. والجَسَدُ جِرْمٌ، لأنّ لـه قَدْراً وتَقْطيعاً. ويقال مَشْيَخَةٌ جِلّةٌ جَريم، أي عظام الأجرام. فأمّا قولُهم لصاحب الصَّوت: إنه لحسن الجِرْم، فقال قوم: الصَّوْتُ يقال له الجِرْم. وأصحُّ من ذلك قول أبي بكر بن دريد إنَّ معناه حَسنُ خروجِ الصّوتِ من الجِرْم. وبنو جارمٍ في العرب. والجارم: الكاسب، وهو قول القائل: * والجارميُّ عميدُها * وجَرْمٌ هو الكَسْبُ، وبه سمِّيَتْ جَرْمٌ، وهما بطنان: أحدهما في قضاعة، والآخر في طيّ. (جرن) الجيم والراء والنون أصلٌ واحد، يدلُّ على اللين والسُّهولة. يقال للبَيْدَرِ جَرينٌ؛ لأنّه مكان قد أُصْلِحَ ومُلِّسَ. والجارن من الثياب: الذي انسَحَق ولانَ. وجَرَنَتِ الدِّرْعُ: لانَتْ وامْلاَسَّتْ. ومن الباب جِرَانُ البعير: مُقَدَّم عُنُقه من مَذْبَحِهِ، والجمع جُرُن. قال: خُذا حَذَراً يا جارَتَيَّ فإنَّني *** رأيتُ جِرَانَ العَوْدِ قد كادَ يَصْلُحُ وذكرَ ناسٌ أنّ الجارنَ ولد الحيّة. فإن كان صحيحاً فهو من الباب، لأنه ليِّن المسِّ أملس. (جره) الجيم والراء والهاء كلمةٌ واحدة، وهي الجَرَاهية. قال أبو عُبيدٍ: جَراهيةُ القوم: جَلَبَتُهُم وكلامُهم في علانيتهم دون سِرِّهم. ولو قال قائل: إنّ هذا مقلوبٌ من الجَهْرِ والجَهْرَاء والجَهارة لكان مَذْهباً. (جرو) الجيم والراء والواو أصلٌ واحدٌ، وهو الصَّغير من ولد الكلب، ثم يحمل عليه غيرُه تشبيهاً. فالجَرو للكلب وغيره. ويقال: سَبُعةٌ مُجْرِيَةٌ ومُجْرٍ، إذا كان معها جِرْوُها. قال: وتَجُرُّ مُجْرِيَةٌ لها *** لحمِي إلى أجْرٍ حَوَاشِبْ فهذا الأصل. ثم* يقال للصَّغيرة من القِثّاء الجِرْوة. وفي الحديث: أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بأَجْرٍ زُغْبٍ"، وكذلك جَُِرْو الحنظل والرُّمّان. يعني أنها صغيرة. وبنو جِرْوة بطنٌ من العرب. ويقال ألقى الرّجُل جِرْوَتَه، أي ربَط جَأْشَه، وصَبَر على الأمر، كأنّه ربط جرواً وسكّنَه. وهو تشبيهٌ. (جري) الجيم والراء والياء أصلٌ واحدٌ، وهو انسياحُ الشيء. يقال جَرَى الماء يَجْري جَرْيَةً وجَرْياً وجَرَياناً. ويقال للعَادة الإجْرِيَّا، وذلك أنّه الوجْه الذي يجري فيه الإنسان. والجَرِيُّ: الوكيل، وهو بيّن الجِراية، تقول جَرَّيت جَرِيّاً واستَجْرَيتُ، أي اتَّخذْت. وفي الحديث: "لا يُجَرِّينَّكم الشّيطان". وسمِّي الوكيلُ جَريّاً لأنّه يَجْري مَجْرى موكّله، والجمع أجْرِيَاء. فأمّا السفينة فهي الجارية، وكذلك الشَّمس، وهو القياس. والجارية من النِّساء من ذلك أيضاً، لأنَّها تُسْتَجْرَى في الخِدمة، وهي بيِّنة الجِراء. قال: والبِيضُ قد عَنَسَت وطال جِراؤُها *** ونَشَأن في قِنٍّ وفي أذْوادِ ويقال: كان ذلك في أيّامِ جِرائها، أي صباها. وأما الجِرِّيَّة، وهي الحَوْصلة فالأصل الذي يعوَّل عليه فيها أنَّ الجيم مبدلة من قاف، كأن أصلها قِرِّيّة، لأنّها تَقْرِي الشيءَ أي تجمعه، ثم أبدَلُوا القافَ جيماً كما يفعلون ذلك فيهما. (جرب) الجيم والراء والباء أصلان: أحدهما الشَّيء البسيط يعلوه كالنبات من جنسه، والآخَر شيءٌ يحوي شيئاً. فالأوّل الجرَب وهو معروف، وهو شيءٌ ينبت على الجلْد من جنسه. يقال بعيرٌ أجرب، والجَمْع جَرْبَى. قال القطران: أنا القَطِرانُ والشُّعراءُ جرْبَى *** وفي القَطِرانِ للجَرْبَى شِفاءُ وممّا يُحمَل على هذا تشبيهاً تسميتُهم السَّماء جَرْباء، شبّهت كواكبُها بجرَب الأجرَب. قال أسامة بنُ الحارث: أرَتْهُ من الجرْباءِ في كلِّ مَنْظرٍ *** طِباباً فمَثْوَاهُ النَّهارَ المَرَاكِدُ وقال الأعشى: تناول كلباً في ديارهم *** وكاد يسمو إلى الجرْباء فارتَفَعا والجِرْبَة: القَرَاح، وهو ذلك القياس لأنّه بسيطٌ يعلوه ما يعلوه منه. قال الأسعر: أما إذا يَعْلُو فثعلبُ جِرْبَةٍ *** أو ذِئبُ عادية يُعَجْرِمُ عَجْرَمَهْ العجرمة:سُرعةٌ في خِفّة. وكان أبو عبيد يقول: الجِرْبة المزرعة. قال بشر: * على جرْبة تعلو الدِّبارَ غُروبُها * قال أبو حَنيفة: يقال للمجَرَّة جِرْبة النُّجوم. قال الشّاعر: وخَوَتْ جِرْبَةُ النّجوم فما تشْـ *** ـرب أُرْوِيَّةٌ بمَرْي الجنُوبِ خَيُّها: أن لا تُمطِر. ومَرْي الجَنُوب: استدرارُها الغَيث. والأصل الآخر الجِراب، وهو معروف. وجرابُ البئر: جوفُها من أعلاها إلى أسفلها. والجَرَبَّةُ: العانة من الحمير، وهو من بابِ ما قَبْله، لأن في ذلك تجمُّعاً. وربَّما سمَّوا الأقوياء من الناس إذا اجتمعُوا جَرَبَّةً. قال: ليس بنا فقرٌ إلى التَّشَكِّي *** جَرَبَّةٌ كحُمُرِ الأبَكِّ (جرج) الجيم والراء والجيم كلمة واحدة، وهي الجادّة، يقال لها جَرَجَة. وزعم ناسٌ أنّ هذا مما صحَّف فيه أبو عُبيدٍ. وليس الأمر على ما ذكَرُوه، والجَرَجَةُ صحيحة. وقياسها جُرَيج اسم رجل. ويقال إنّ الجَرِجَ القَلِق. قال: * خلخالُها في ساقها غيرُ جَرِجْ * وهذا ممكنٌ أن يقال مبدل من مَرِج. قال ابن دريد: والجَرَجُ الأرض ذاتُ الحجارة. فأما الجُرْجة لِشيءٍ شِبْه الخُرْج والعَيْبة، فما أُراها عربيةً مَحْضة. على أنّ أوساً قد قال: ثلاثةُ أبرادٍ جيادٍ وجُرْجَة *** وأدْكَنُ من أرْيِ الدُّبور مُعَسَّلُ (جرح) الجيم والراء والحاء أصلان: أحدهما الكسب، والثاني شَقّ الجِلْد. فالأوَّل قولهم [اجترح] إذا عمل وكَسبَ. قال الله عزّ وجلّ: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ} [الجاثية 21]. وإنَّما سمى ذلك اجتراحاً لأنه عَمَلٌ* بالجوَارح، وهي الأعضاء الكواسب. والجوارحُ من الطَّير والسباع: ذَوَاتُ الصَّيد. وأما الآخَر [فقولهم] جرحَهُ بحديدةٍ جرْحاً، والاسم الجُرْح. ويقال جرَح الشاهدَ إذا ردّ قولَه بِنَثاً غيرِ جميل. واستَجْرَحَ فلانٌ إذا عمل ما يُجْرَح من أجله. فأمَّا قول أبي عبيدٍ في حديث عبد الملك: "قد وعظتُكم فلم تزدادُوا على الموعظة إلاّ استجراحا" إنه النُّقصان من الخير، فالمعنى صحيح إلاّ أنّ اللفظ لا يدلُّ عليه. والذي أراده عبدُ الملك ما فسَّرناه. أي إنّكم ما تزدادون على الوعْظ إلاّ ما يكسبكم الجَرْحَ والطَّعنَ عليكم، كما تُجرَح الأحاديث. وقال أبو عبيد: يريد أنَّها كثيرة صحيحها قليل. والمعنى عندنا في هذا كالذي ذكرناه مِن قَبْل، وهو أنَّها كثُرتْ حتى أحوج أهلَ العلم بها إلى جرْح بعضها، أنّه ليس بصحيح. (جرد) الجيم والراء والدال أصلٌ واحد، وهو بُدوُّ ظاهِر الشَّيء حيث لا يستُره ساتر. ثم يحمل عليه غيرُه ممَّا يشاركه في معناه. يقال تجرَّد الرَّجل من ثيابه يتجرَّدُ تجرُّداً. قال بعضُ أهل اللُّغة: الجَرِيد سَعَفُ النَّخل، الواحدة جريدة، سمِّيت بذلك لأنه قد جرِد عنها خُوصها. والأرْضُ الجَرَد: الفضاء الواسعُ، سمِّي بذلك لبُروزه وظُهوره وأن لا يستره شيءٌ. ويقال فرس أَجرَدُ إذا رَقَّت شَعْرتُه. وهو حسن الجُرْدة والمتجرَّد. ورجلٌ جارُودٌ، أي مشؤوم، كأنَّه يَجْرُدُ ويَحُتُّ. وسنةٌ جارودةٌ، أي مَحْلٌ، وهو من ذلك، والجَراد معروفٌ. وأرضٌ مجرودةٌ أصابها الجَرادُ. وقال بعضُ أهلِ العِلم: سمِّي جراداً لأنّه يجرُد الأرضَ يأكلُ ما عليها. والجَرَدُ: أن يَشْرَى جلْدُ الإنسان من أكل الجَراد. ومن هذا الباب، وهو القياس المستمرُّ، قولهم: عامٌ جرِيدٌ، أي تامٌّ، وذلك أنَّه كَمَُِل فخرج جريداً لا يُنْسَب إلى نقصانٍ. ومنه: "ما رَأَيْتُهُ مُذْ أجرَدَانِ وجَرِيدانِ" يريد يومين كاملين. والمعْنى ما ذكرته. ومنه انجرَدَ بنا السَّيرُ: امتدَّ. فأمّا قولهم للشيءِ يذهب ولا يُوقَف [له] على خبرٍ: "ما أدري أيُّ الجَرَاد عارَهُ" فهو مثلٌ، والجَراد هو هذا الجَرادُ المعروف. (جرذ) الجيم والرال والذال كلمةٌ واحدة: الجُرَذُ الواحد من الجُِرْذان، وبه سمِّيَ الجَرَذُ الذي يأخُذُ في قوائم الدابّة. فأمّا قولهم رجل مُجَرَّذٌ أي مجرَّب، فهو من باب الإبدال، وليس أصلاً.
|